 عبد السلام محمد الأحمر
عبد السلام محمد الأحمر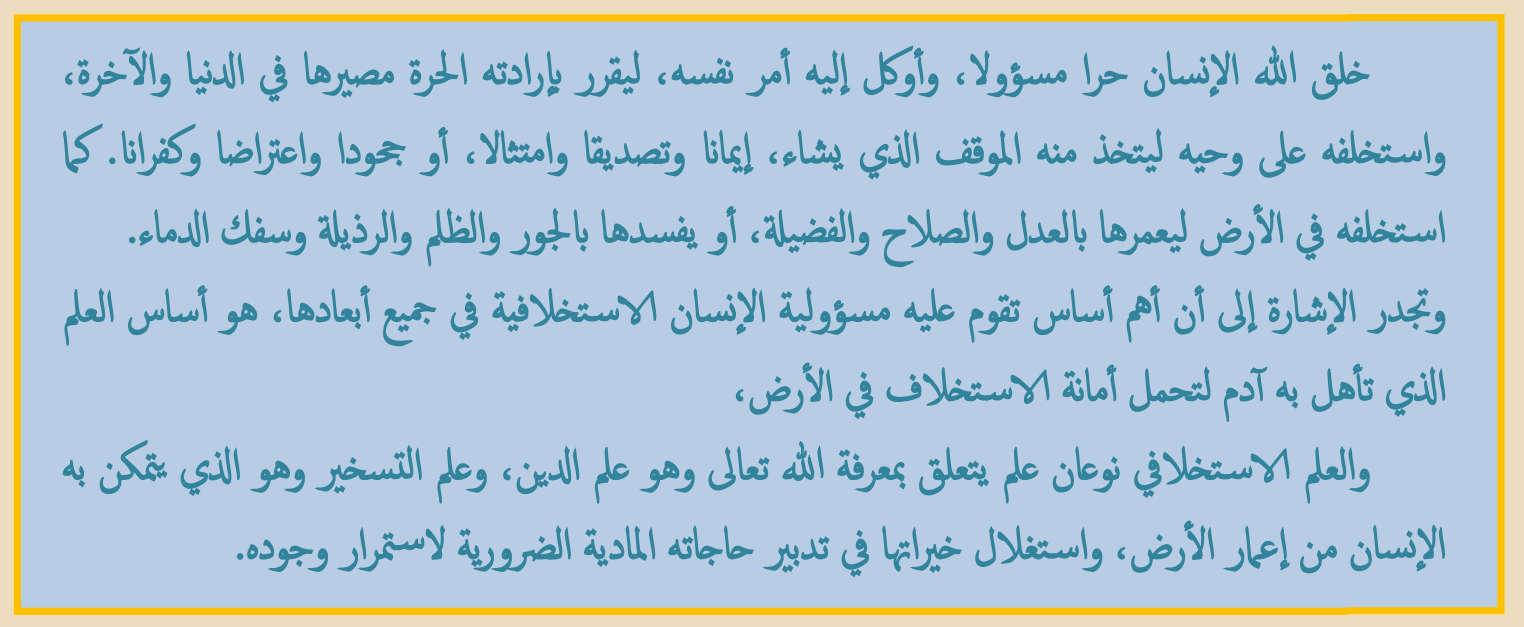 فالمعرفة الدينية يحصلها من دراسة وتدبر آيات الله المسطورة في وحيه المنزل، وأيضا من النظر والبحث في آيات الله المنشورة في الأنفس والآفاق، {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ} [فصلت: 53]. وانطلاقا من فهمه الصحيح أو الخاطئ لهذين النوعين من الآيات، تتحدد طبيعة ممارسته لمسؤوليته في الحياة.
فالمعرفة الدينية يحصلها من دراسة وتدبر آيات الله المسطورة في وحيه المنزل، وأيضا من النظر والبحث في آيات الله المنشورة في الأنفس والآفاق، {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ} [فصلت: 53]. وانطلاقا من فهمه الصحيح أو الخاطئ لهذين النوعين من الآيات، تتحدد طبيعة ممارسته لمسؤوليته في الحياة.