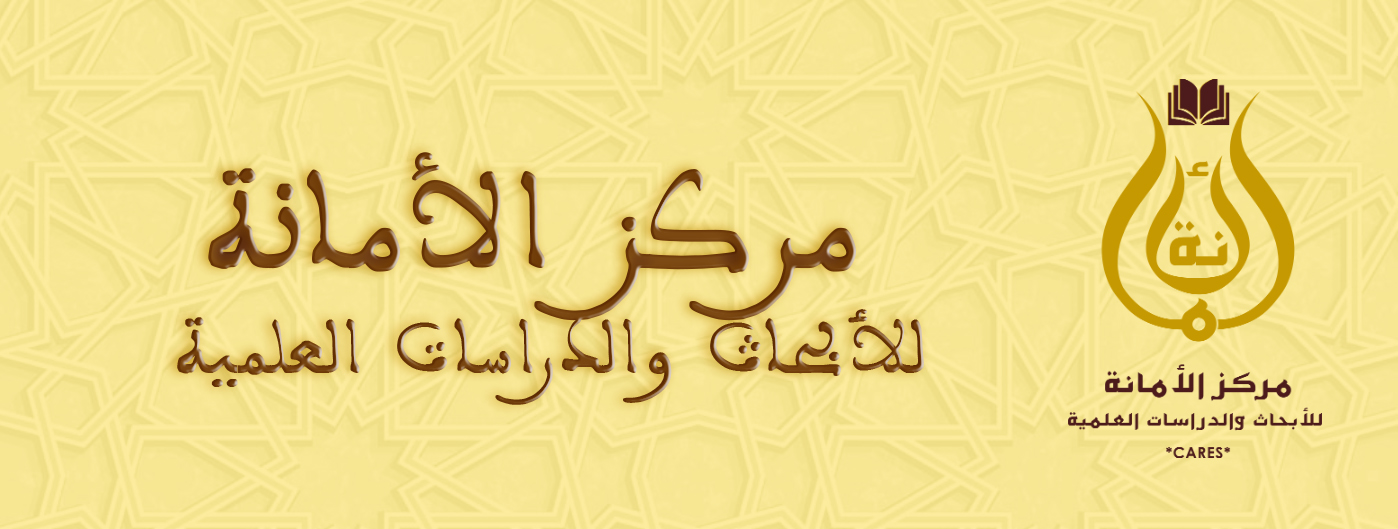المناهج التَّعليميَّة لِمادَّة التَّربية الإسلاميَّة: «اَلإطار النَّظريّ والتَّطبيقات العمليَّة في ضوء تحدِّيات الواقع المُعاصِر»

ناقش الطالب الباحث عبد الجليل البكوري بتاريخ 20 شوال 1443 الموافق 21 ماي 2022م أطروحتة لنيْل درجة الدُّكتوراه في الآداب الموسومة ب: “المناهج التَّعليميَّة لِمادَّة التَّربية الإسلاميَّة: «اَلإطار النَّظريّ والتَّطبيقات العمليَّة في ضوء تحدِّيات الواقع المُعاصِر»” بمركز دراسات الدّكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانيَّة والتَّرجمة، تكوين “شمال المغرب وعلاقته بحضارات الحوض المُتوسطيِّ” بجامعة عبد المالك السعديّ، كليّة الآداب والعلوم الإنسانيَّة بتطوان.
أعضاء المناقشة:
الدكتور خالد الصمدي المدرسة العليا للأساتذة بتطوان مشرفا.
الدكتور توفيق الغلبزوري كلية أصول الدين رئيسا.
الدكتور هشام تهتاه كلية الآداب والعلوم الإنسانية عضوا.
الدكتور عبد المجيد حدوش المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين تطوان عضوا.
الدكتور لخلافة المتوكل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت عضوا.
ملخَّص الأطروحة.
السياق العام للأطروحة:
لئن كانت المناهج التَّعليميَّة قد عَرَفت تَطوُّراً واضِحًا في العِقديْن الأخيرَيْن؛ فإنَّ ذلك قد طَرَحَ تحدِّياتٍ حقيقيَّةً واجهَت مُختلف الموادِّ التَّعليميَّة، حتَّىٰ وصل الأمر في كثيرٍ من الأحيان إلىٰ حدودِ طرح السُّؤال: هل تُلائم هذه المادَّةُ التَّعليميَّة ومناهِجُها وطرقُ تدريسها النَّظريَّات الحديثةَ في مجال التَّربية والتَّكوين؟ وقد لا يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل يتطوَّرُ أكثر لِيصل أحيانًا إلىٰ طرح سؤالِ الجدْوىٰ من تدريس هذه المادَّة أو تلك، وهل يَجب تَضمينها المنهاجَ التَّعليميّ المدرسيّ؟ أم يُمكن إسنادُها لمؤسَّساتٍ اجتماعيَّةٍ أو دينيَّةٍ أخرىٰ، إذْ هي أَحَقُّ وأجدر بها وأنسب لها من غيْرها؟! وما مدىٰ مواءمة مُحتواها المعرفيِّ والقيَميِّ والمهاريِّ للتَّوجُّهات الحديثة في سياسات التَّعليم؟ وما مدىٰ تلبيَتهِا لمُتطلَّبات سوق الشُّغل؟ … إلخ.
ولو شئنا الحقيقة؛ فإنَّ مثلَ هذه الإكراهات لم تَستثْنِ أيَّ مادَّةٍ مِن الموادِّ التَّعليميَّة. نعم؛ قد اختلفت حِدَّتها وآثارُها حسَب طبيعةِ كُلِّ مادَّةٍ وخصوصيَّاتها، لكنَّها بكُلِّ تأكيدٍ لم تستثنِ أيَّة واحِدةٍ منها. ولعلَّنا لا نقول جديدًا إن ذكرنا أنَّ موادَّ العلوم الإنسانيَّة كانت أكثر تأثُّرًا مِن غيرها، ولهذا سَعَىٰ القائمون عليْها بجُهدٍ جرِّيءٍ وغير مسبوقٍ إلىٰ اقتحام عقبة تجديد مناهجها وتحديثِ تدريسيَّتها رغبةً في مواءمتها مع النَّظريَّات التَّربويَّة الحديثة، وبالفِعل؛ قد استطاعت بعض الموادِّ أن تتجاوزَ ولو جُزئيًّا أزمتها وتستقِرَّ علىٰ برِّ أمانها، فيما بقيَت موادُّ أخرىٰ تتعرَّضُ بين الفينة والأخرىٰ إلىٰ هزَّاتٍ تسعىٰ إلىٰ زحزحةِ وجودها المادِّيّ والمعنويّ في المنهاج المدرسيِّ الرَّسميّ.
في ظلِّ هذا السِّياق الذي قدَّمْتُه؛ لم تكُن مادَّة التَّربية الإسلاميَّة بِدعًا من تلك الموادِّ، بل عاشت بدورِها مخاضاً عسيرًا، وكانت -كصُويْحِباتها من موادِّ العلوم الإنسانيَّة- أحوَج ما كانت إلىٰ رؤىٰ وتوجُّهاتٍ جديدةٍ ومُجَدِّدةٍ، وعلىٰ نفسِ المنوال نقول: نعم؛ قد بُذلت أيضًا جهودٌ في نفسِ المنحىٰ –أي: منحىٰ التَّطوير والتَّحديث والمواءمة- اختلفت مساراتُها وتوجُّهاتُها بحسب خصوصيَّات بلادِها فاختلفت تبعًا لذلك نتائجُها، لكنَّ واقع حالِ هذه المادَّة لا يزال يشهَدُ أزمةً حقيقيَّةً تزداد عُمقًا وتعقيدًا مع مرور الزَّمن، خصوصًا وأنَّ جُزءًا من الإشكالات التي تواجه مادَّة التَّربية الإسلاميَّة نوعيّةٌ وذات حساسيَّة كبيرة، مِمَّا يُعمِّق الأزمة ويزيد مِن تداعيَّاتها.
إزاء هذا الوضع؛ تساءل الباحِثُ:
ألَا مِن سبيلٍ لتطوير مناهج مادّة التَّربية الإسلاميَّة يُجَنِّبُنا مثل هذا الشَّتات الذي يهدر الجهود ويضيِّع علىٰ مناهج المادَّة فُرصًا ثمينةً للتّطوير بل والتَّعزيز والتَّمكينِ أيضًا داخل النُّظُم التَّربويّة العربيّة؟
وقد تفرَّع عن هذه الإشكاليَّة الرئيسيّة، إشكالاتٌ فرعيَّة أخرىٰ:
1) ما هو الإكراه الحقيقيُّ الذي يُهدِّد الوجودَ المادِّيَّ والمعنويَّ لِمادَّة التَّربية الإسلاميَّة؟
2) وما آثاره علىٰ مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة؟
3) وما التَّحدِّيات التي يطرحُها؟
4) ثُمَّ ما السَّبيل إلىٰ رفعِ تلك التَّحدِّيات؟
ولكيْ لا يتوه الباحِثُ في أشغال الأطروحة؛ افترَض مجموعةً من الفرضيَّات التي صاغها كإجاباتٍ أوَّليَّةٍ علىٰ تلكُم الإشكالاتِ المطروحة، وعليه فإنَّ الباحِث يفترضُ:
1) أنَّ السَّبيل غير المسلوك بإتقانٍ بعد؛ هو التَّشخيص الصَّحيح لواقع مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة، والتَّحديد الدَّقيق لتحدِّياتها.
2) أنَّ الإكراهَ الحقيقيَّ الذي يُهدِّدُ مناهجَ مادَّة التَّربية الإسلاميَّة في واقعها ومُتوَقَّعها في المُستقبل هو الإكراه “الأيديولوجيِّ”.
3) أنَّ هذا الإكراهَ “الأيديولوجيَّ” هو الذي يُفرِزُ أهمَّ التَّحدِّيَّات التي يطرحُها الواقعُ المُعاصِر علىٰ مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة.
4) أنَّ بإمكان مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة أن تُواجهَ الإكراه الأيديولوجيَّ وما ينتج عنه مِن مخاطرَ عن طريق رفعها للتَّحديات ذات الأولويَّة.
وفي ارتباطِ وثيقٍ بإشكاليَّة الأطروحة وفرضيَّاتها، تمَّت صياغَةُ الأهداف الإجرائيَّة التَّالية لتكون مُعينَةً علىٰ إنجازِ الأطروحة وأجرأةِ خطواتها:
1) التَّعرُّف علىٰ الأيديولوجيا وعلاقتها بالتَّربية عامَّة وبالمناهج التَّعليميَّة خاصَّةً.
2) الكشف عن آثار الأيديولوجيا علىٰ مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة والتَّحدِّيات المُعاصِرة الناجمة عنها.
3) الخلوص إلىٰ محدِّداتٍ منهجيَّة وتوجُّهاتٍ مُستقبليَّةٍ تُسهِم في تطوير مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة وتعزيز مكانتها.
ولتحقيق هذه الأهداف توسَّلت الأطروحة بالأسئلة الرئيسة والفرعيَّة التَّالية:
1ـ الأسئلة المُرتبطةُ بالهدفِ الأوَّل:
ـ ما هي «الأيديولوجيا»؟
ـ ما أسُسها؟
ـ ما تاريخُها؟
ـ ما هي أهمُّ وأبرز الأيديولوجيَّات المُعاصرة؟
ـ ما علاقةُ «الأيديولوجيا» بالتَّربية؟
ـ ما هي طبيعة هذه العلاقة أكاديميًّا؟
ـ ما هي تجلِّيَّاتُها واقِعِيًّا؟
ـ كيف تؤثِّرُ الأيديولوجيات المُعاصِرة في التَّربية؟
2ـ الأسئلة المُرتبطة بالهدف الثَّاني:
ـ ما آثار الأيديولوجيَّات المُعاصرة علىٰ مناهج مادة التَّربية الإسلاميَّة؟
ـ ما آثار الأيديولوجيَّات الغربيَّة؟
ـ ما آثار الأيديولوجيَّات العربيَّة؟
ـ ما التَّحدِّيَّات النَّاتجة عن تلك الآثار؟
3ـ الأسئلة المُرتبطة بالهدف الثَّالث:
ـ ما هي المُحدِّدات المنهجيَّة لرِفعِ تلك التَّحدِّيات؟
ـ ما السَّبيل الأمثل الذي يمكن نهجُه للحدِّ -أو التقليل- آنيًّا من تلك الآثار؟
ـ كيف يُمكن تعزيز مكانة منهاج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة؟
ـ ما هي التَّوجُّهات المُستقبليَّة التي يجب الاعتناء بها لتحقيق ذلك؟
وفي سياقِ الإجابة عن هذه الأسئلة تبلورت خُطَّة الأطروحة علىٰ الشَّكل التَّالي:
ـ الفصل التَّمهيديّ:
خُصِّصَ هذا الفصلُ ليكون الفصل التَّمهيديّ الذي يتضمَّنُ عادَةً المُقدِّمة العامَّة التي تضعُ الأطروحةَ في سياقِها. ولِكيْ تكتسب الأطروحة المشروعيَّة لإنجازها؛ طرحَ الباحِثُ بعدَ المُقَدِّمة الإشكاليَّات التي ستُعالِجُها أطروحتُه مع توضيحِها لتستبين عائداتُ مُعالَجَتها، كما تضمَّن هذا الفصلُ فرضيَّاتٍ رَشَّحها الباحِثُ بعد تأمُّله في موضوع الأطروحة وإشكاليَّتها لتكون الإجابَةَ أو جُزءًا مِن الإجابة عن الإشكاليَّة.
وفي سَعيِه لاختبار تلك الفرضيَّات أطَّر الباحثُ مُجريات البحثِ بمجموعةٍ مِن الأسئلة التي تُقسِّمها إلىٰ خطواتٍ إجرائيَّة وعمليَّةٍ رابِطًا كُلَّ إجراءٍ بهدفٍ مِن أهدافِ البحث، وقد حرص الباحِثُ ألَّا تكونَ أهداف أطروحته حالِمَةً فيَكون ذلك ضربًا مِن القولِ بلا عملٍ أو الادِّعاء بما لم يُفعل، فقامَ بحَدِّ مسافة تحرُّكها بالحدود البحثيَّة التي تجعلها أكثر عِلميَّةً وأكثر قابليةً للتَّحقُّق في إطار ما تسمح به مساحة الأطروحة الجامعيَّة.
وكل هذا ليكون الطَّريق الذي ستسلُكه الأطروحة بيِّنًا وواضِحًا ومُعترِفًا بحدوده، أمَّا عنِ الطَّريقة فقد وضَّحها الباحِثُ حين تطرَّق لمنهجيَّة الأطروحة، ثم اختُتِم الفصْلُ بتحديد مُصطلحات الأطروحة وبالإشارة إلىٰ الدِّراسات السَّابقة في ضوء المداخل السَّائدة في تشخيص أزمة مادَّة التَّربية الإسلاميَّة، دون أن يغفل عن توضيح الجديد الذي سيُضيفه هذا المجهود وسيتميَّزُ به.
ـ الفصل الأوَّل: الإطار النَّظريّ ﻟ «الأيديولوجيا» والتَّربية.
تلىٰ التَّمهيد مبحثانِ اثنان:
اعتنىٰ الأوَّلُ بدراسةِ «الأيديولوجيا» مِن داخِلِها، وذلك للتَّعرُّف علىٰ مفهومها وتاريخه مُسَلِّطًا الضوءَ علىٰ مُنطلقات نشأته ومُضَمِّنًا إيَّاه -أي السِّياق التَّاريخيّ- الآراء والمواقف المختلفة التي صاحبته، ثم عَمَد الباحِثُ إلىٰ بيانِ خصائص ووظائف «الأيديولوجيا» باعتبارها أهمّ ما يرتبط بالأطروحة، حيث إنَّ الباحِثَ يسعىٰ في النِّهاية إلىٰ دراسةِ مدىٰ تأثير الأيديولوجيا علىٰ مناهج مادة التربية الإسلامية، الأمر الذي يتطلَّب معرفة خصائص ووظائف هذا الفاعِل (الأيديولوجيا) إضافةً إلىٰ خلفيَّته ومرجعيَّاته…
في حين اعتنىٰ المبحثُ الثَّاني بدراسةِ واقعِ هذه الأيديولوجيا في عالمِنا المُعاصِر، فقام برصدِ أبرزِ التَّوجُّهات الأيديولوجيَّة الغربية والعربيَّة-الإسلاميَّة المُعاصِرة، والتَّعرُّف علىٰ واقِعِها، تمهيدًا لدراسة علاقتها بالنُّظم التَّربويَّة، ولهذا تضمَّن هذا المبحثُ أيضًا نماذج وتجارب مُعاصِرة لتطبيقات الأيديولوجيا في مجال التَّربية والتَّعليم ومدىٰ تأثيرها علىٰ السِّياسات التَّعليميَّة والمناهج الدِّراسيَّة.
وفي الأخير جاءت المناقشة والتَّعقيب ليُعطيَ الباحِثُ رأيه وقناعته التي خلُص بها بعد إنجازه لهذا المبحث، كما تمَّ مِن خلَال هذا التَّعقيب تنظيم نتائج هذا المبحث، وكان أهمُّها التَّفريق بين نوعين من الأيديولوجيا إزاء التَّربية الإسلاميَّة، سُمِّيَت الأولىٰ بالأيديولوجيَّات الضَّاغِطة، والثَّانية بالأيديولوجيات المُتجاذبة أو المُتشاكِسة، وهو ما أدَّىٰ إلىٰ فتحِ المجال للانتقال إلىٰ الفصل المُوالي.
ـ الفصلُ الثَّاني: دراسةٌ تطبيقيَّة لواقع مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة في ضوء الإكراه «الأيديولوجيّ».
أيْضًا تلىٰ التَّمهيد مبحثانِ اثنان:
درس الأوَّل تأثير الأيديولوجيات الضَّاغِطة علىٰ مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة، وتعلَّق الأمر بمناهج التَّعليم الدِّينيِّ في المملكة العربيَّة السَّعوديَّة ومنهاج التَّربية الإسلاميَّة بالمملكة المغربيَّة، وقد تبيَّن كيف أنَّ هذا الضَّغط الأيديولوجيِّ يُمارس إصلاحاته القسرية علىٰ تلك المناهج، وكيف يتحكَّمُ في مفردات المنهاج ومحتواه ويُوجِّهه إلىٰ الوِجهة التي يرتضيها.
أمَّا المبحث الثَّاني فقد درس تأثير الأيديولوجيَّات المُتجاذبة في الوطن العربيِّ علىٰ مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة، وتعلَّق الأمر بمناهج التَّعليم الدِّينيِّ في الجمهوريَّة اللُّبنانيَّة ومنهاج القرآن الكريم والتَّربية الإسلاميَّة في الجمهوريَّة العراقيَّة، وقد تبيَّن كيف أنَّ التجاذُب الأيديولوجيِّ الداخليّ لا يقلُ خطورةً عن الضغوط الأيديولوجيَّة الخارجيَّة، فقد أدَّىٰ إلىٰ حذف التَّعليم الدِّيني من قائمة الموادِّ الدِّراسيَّة الرَّسميَّة بلُبنان، كما أدَّىٰ إلىٰ اختلالاتٍ عميقةٍ جِدًّا في بِنية المنهاج العراقيِّ وصل إلىٰ حدِّ رداءةِ المُنتج تربويًّا وتقنيًّا وفنِّيًّا.
وكما في الفصل الأوَّل عقَّب الباحِثُ علىٰ نتائج هذه الدِّراسة التَّطبيقيَّة، كما أعادَ التَّأمُل فيها ليخلُصَ بأبرزِ التَّحدِّيات التي يطرحُها الإكراه الأيديولوجيّ علىٰ مناهج مادَّة التّربية الإسلاميَّة فحدَّدها كالآتي:
ـ تحدِّي الفصل بين الأيديولوجيا ومناهج التَّربية الإسلاميَّة.
ـ تحدي تجديد الخطاب التَّربويِّ في مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة.
ـ تحدي بناء وتصميم مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة في ضوء النَّظريَّات التَّربويَّة الحديثة.
ـ تحدِّي إرساء معايير تقييم وتقويم مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة.
وقد شَكَّلت هذه التَّحدِّيات موضوعَ المُحدِّدات المنهجيَّة والتَّوجُهات المُستقبليَّة التي سيقترحها الباحث في الفصل الموالي.
ـ الفصل الثَّالث: التَّحدِّيات الرَّافعة لتطوير مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة: مُحدِّداتٌ منهجيَّةٌ وتوجُّهاتٌ مُستقبليَّةٌ.
علىٰ نفسِ المِنوال، تلىٰ التَّمهيد مبحثان أيضًا:
جَمع المبحث الأوَّل التَّحدِّيَيْنِ الأوليَيْنِ (تحدِّي الفصل بين الأيديولوجيا ومناهج التَّربية الإسلاميَّة، وتحدي تجديد الخطاب التَّربويِّ في مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة) باعتبارهما تحدِّيَيْنِ يقعان في الجانب النَّظريِّ، وذلك لكونِهما يرتبطان بالتَّوجُّهات والفلسفة والتَّصوُّرات… التي ستُؤثِّر في مُحتوىٰ المنهاج التَّعليميِّ الذي سيُسَلَّم لأهل الاختصاص مِن أجل هندسته وتصميمه وبنائه وفق القواعد المُتعارف عليها في تخطيط المناهج وصياغتها، وقد قدَّم الباحِثُ بشأنِهما مُحدِّدات منهجيَّة لتعميق البحث فيهما -أي: التَّحدِّيان- كما قدَّم توجُّهات مُستقبليَّة لأجل رفعِهما وتحقيق الإصلاح والتَّطوير المنشوديْن لمناهجنا في مادَّة التَّربية الإسلاميَّة.
أمَّا المبحث الثَّاني فقد تناول التَّحدِّيَيْن المُتبقِّيَيْن (تحدي بناء وتصميم مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة في ضوء النَّظريَّات التَّربويَّة الحديثة، وتحدِّي إرساء معايير تقييم وتقويم مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة) باعتبارهما يتعلَّقان بإجراءات عمليَّة وتطبيقيَّة في بناء مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة، وقد قدَّم الباحِثُ بشأنِهما مُحدِّدات منهجيَّة لتعميق البحث فيهما -أي: التَّحدِّيان- كما قدَّم توجُّهات مُستقبليَّة لأجل رفعِهما وتحقيق الإصلاح والتَّطوير المنشوديْن لمناهجنا في مادَّة التَّربية الإسلاميَّة.
وكان للتَّعقيب في نهاية هذا الفصلِ طعمٌ منهجيٌّ واستشرافيُّ أيْضًا، حيث أشار فيه الباحث ولو باقتضاب شديدٍ إلىٰ أهمِّ المقوِّمات التي تحتاجها هذه المحدِّدات المنهجيَّة والرُّؤىٰ المُستقبليَّة للتَّفعيل.
ـ الخاتمة (مع النَّتائج والتَّوصيات)
وفي الخاتمة قدَّم الباحِثُ خلاصةً تركيبيَّة لما ورد في الأطروحة وقدَّم نتائجها واستخلص توصِيَّاتها.
ومِمَّا لا ينبغي غضُّ الطَّرفِ عنه في هذا المُلخَّص حدودُ الأطروحةِ التي توقَّفت عندها، إذ تبدو واضِحةً مِن خلال طبيعة الأسئلة المطروحة استحالةُ إنجاز هذه الأطروحة إن هيَ حاولت أن تُقَدِّمَ إجاباتها مُستقصيةً لكُلِّ تجارب البُلدان العربيَّة علىٰ اختلافِ ظروفها ومناهجها التَّعليميَّة. ولهذا لجأ الباحِثُ -كما هو معمولٌ به عادةً في إنجاز الأطاريح الجامعيَّة- إلىٰ تسييجِ أطروحته بحدودها التي تُمَكِّن من إنجازها، وهي كالآتي:
1ـ الاكتفاء بالإكراه «الأيديولوجي» ودراسة التَّحدِّيات المُنبثِقة عنه:
لا يكاد يغيب عن النَّدوات والمؤتمرات والكتابات المتخصِّصة في مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة، وكذلك في الآراء المُعبَّر عنها من طرف المُدرِّسين والقائمين علىٰ المادَّة، الحديثُ عن جُملةٍ مِن الإكراهات التي تُواجهها وتواجِه مناهِجها، وكُلّها بطريقةٍ أو بأُخرىٰ تحمِلُ من الصّواب والوجاهة ما تستحِقُّ معه أن تُولىٰ بالاهتمام، وكان بالإمكان أن يعمد الباحِثُ إلىٰ استقراء وِجهات النَّظر تلك واستنطاق نتائج وتوصيَّات تلك المؤتمرات، واستقراء تلك الكتابات، واستطلاع رأيِ المُدرِّسين ولكنَّ الباحِثَ لم يفعل ذلك نظرًا للآتي:
في الوقت الذي اتَّجهت فيه الدِّراسات للبحث عن سبُل تقويةِ مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة لتكون قادِرةً علىٰ أداء وظيفتها في مواجهةِ تحدِّيات الاشتراكيَّة ثم اللِّيبراليَّة والعلمانيَّة والعولمة والحداثة… حتَّىٰ وجدت نفسها أمامَ موجة ما بعد الحداثة لتأخذ جهودها إلىٰ مُنعطفٍ آخر جديدٍ لرُبَّما سيستدعي مُراجعةَ كثيرٍ مِمَّا جاءت به حول الاشتراكية والليبراليَّة… بالإضافة إلىٰ ذلك؛ فإنَّ النَّفَسَ الجامِعَ بين هذه الدِّراسات أنَّها تناولت تلك المفاهيم من زاوية أنَّها مفاهيمٌ تحمل مدلولاتٍ فكريَّةٍ وقيمَّيَّةٍ وسلوكيَّةٍ غربيَّةٍ تُناقِض التَّربية الإسلاميَّة، وتحمِل نزعةً عدائيَّةً تآمريَّةً علىٰ مناهجها.
وكان بالإمكان أن يَتناول الباحِثُ بِدوْرِهِ تلك المفاهيم علىٰ هذا النَّحوِ المُجزَّأ، ثُمَّ يُناقش كُلَّ واحدةٍ منها علىٰ حدةٍ ويرصد طبيعة علاقتها بمناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة، ولكن ما استرعىٰ انتباه الباحِث أنَّ كل هذه المفاهيم لَم تبقَ مفاهيم مجرَّدة تدور في فلَك النَّظريات وإنَّما تحوَّلت -فعلًا- إلىٰ تيَّاراتٍ مُنَظَّمة فاعِلة في مُختلف الميادين الاجتماعيَّة والسياسيَّة والتَّربويَّة والمعرفيَّة… مُشَكِّلَّةً في النِّهاية توجُّهاتٍ وتكتُّلاتٍ أيديولوجيَّة ضاغِطة. ولهذا رأىٰ الباحِثُ في امتلاك الأدوات المنهجيَّة للتَّعامل مع ما هو «أيديولوجي» المنجىٰ مِن مثل هذه الصَّدمات المُرتدَّة، ولهذا اعتبر الباحِثُ أنَّ تلكَ التَّحدِّيات إنَّما تنتظم في حقيقةِ الأمر داخلِ سياق «الأيديولوجيا» لأنَّه السِّياق الطبيعيُّ لها وإن حاول البعضُ أن يُثبت غير ذلك.
2ـ نماذج الدِّراسة التَّطبيقيَّة:
اقتصرت هذه الأطروحة في فصلِها التَّطبيقي علىٰ دراسةِ عيِّنةٍ مكوَّنة مِن أربع تجارب عربيَّة في مجال تطوير مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة وهي:
أ ـ تجربة المملكتيْن: العربيَّة السَّعوديَّة والمغربيَّة.
ب ـ تجربة الجمهوريَّتيْن: اللُّبنانيَّة والعِراقيَّة.
فتميَّزت هذه العيِّنات بالتَّمثيليَّة فيما يخصُّ نظام الحُكم بشكلٍ واضح، والتَّوازُن في عيِّنات كُلِّ نظام (دولتيْن ملَكيَّتين، ودولتيْن جمهوريَّتيْن)، وقد حرص الباحِثُ علىٰ هذه التَّمثيليّة وإن لم تظهر بشكلٍ واضحٍ أثناء دراستِه لأنّ نظام الحُكم يرتبط إلىٰ حدٍّ كبيرٍ بالأيديولوجيا.
كما حَرص الباحِثُ علىٰ أن تكون هذه العيِّنات ذات تمثيليَّة وتوازنٍ أيضًا فيما يخص النَّمط “اللُّغويّ” وما ينطوي عليه من توجُّهاتٍ تربويَّة فكانت كالتالي:
أ ـ الفرانكوفونيَّة: ومثَّلتها التَّجربتيْن: المغربيَّة واللُّبنانيَّة.
ب ـ الأنجلوساكسونيَّة: ومثَّلتها التَّجربتيْن: السَّعوديَّة والعراقيَّة.
ولا تُعدُّ هذه التَّمثيليَّة كافيَّةً لتُسَوِّغَ هذا الاختيار؛ إذ لابُدَّ مِن وجود مُبرِّرَّاتٍ قويَّة مِن شأنها أن تخدِم مُعالجتنا لإشكاليَّات الأطروحة وما انبثق عنها مِن فرضيَّاتٍ وأهدافٍ وأسئلةٍ، ولهذا؛ إن عُدنا إلىٰ كُلِّ ما سبق فسنجِدُ أنَّ الدِّراسة التَّطبيقيَّة تتغيَّىٰ في النِّهايةِ رصدَ آثار «الأيديولوجيا» علىٰ مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة والوقوف علىٰ تحدِّيَّاتها المُعاصِرة، مِمَّا يعني أنَّ الاختيار للعيِّنات يجب أن يستحضر هذا المُعطىٰ ولا يغفل عنه، وهذا ما تمَّ بالفعل، ونوجِز القول فيه كما يلي:
ـ التَّجربة السّعوديَّة: تمَّ اختيار هذه التَّجربة نظرًا لكون المملكة العربيَّة السّعوديَّة أكثر الدُّول العربيَّة التي اتَّجهت إليها الأنظار بعد الحادي عشر من سبتمبر، وتمَّ وصمُها بالدَّولةِ المُصدِّرة للإرهاب والدَّاعِمة له، خصوصًا في ظلِّ اختياراتها الدِّينيَّة وما أفرزته من تيَّاراتٍ غالبًا ما تُدعىٰ بالسَّلفيَّة والأصوليَّة، كما تمَّ اختيار هذه التَّجربة لكونها من بين التَّجارِب الأكثر حضورًا في تقارير المُنظَمَّات الحقوقيَّة الدَّوليَّة.
ـ التَّجربة المغربيَّة[1]: وتمَّ اختيارُ هذه التَّجربة لأنَّها استطاعت أن تُبلوِر مفهومًا جديدًا[2] لمادَّة التَّربية الإسلاميَّة، انعكس بشكلٍ إيجابيٍّ ولافتٍ علىٰ مِنهاجها فجعله مُنفرِدًا ومتفّرِّدًا عن باقي التَّجارب العربيَّة الأخرىٰ، خصوصًا في مواجهته للتَّوجُّهات المُخالِفة التي تخرج بيْن الفينة والأخرىٰ في مختلف وسائل النَّشر والتَّواصُل والأنشطة العِلميّة والنِّقاشات السِّياسيَّة…
ـ التَّجربة اللُّبنانية: أمَّا اختيار الباحِث لهذه التَّجربة رافقه استغرابٌ شديدٌ للغاية، إذ شكَّلت هذه البلاد استثناءً مِن بين جميع الدُّول العربيَّة، حيث ألغت التَّعليم الدِّينيَّ مِن منهاجها الرَّسمي تاركةً إيَّاه للمدارس الخاصَّة، وكانت للحرب الأهليَّة بين المسيحيين الموارنة، والمُسلمين الشِّيعة والسُّنة، والدُّروز، تأثيرًا بالغًا لاتخاذ هذا القرار.
ـ التَّجربة العِراقيَّة: وتمَّ اختيارها نظرًا لما عرفته هذه البلاد مِن صراعاتٍ أيديولوجيَّة خطيرةٍ بعد غزوها مِن طرف الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة التي أذكت بعد ذلك مُباشرةً نزاعاتٍ طائفيَّة وغذَّتها بتوظيف المُعطىٰ الدِّيني، فأثَّر ذلك سلْبًا علىٰ مختلف الأوضاع ومجالات الحياة في العِراق، فعمدت الأطروحة إلىٰ دراسة آثار ذلك علىٰ منهاج مادَّة القرآن الكريم والتَّربية الإسلاميَّة.
يُضاف إلىٰ كُلِّ ما سبقَ أنَّ الباحِثَ أثناء اشتغاله علىٰ عيِّنات الدِّراسة التطبيقيَّة، لم يتناول جميع المُستوياتِ التَّعليميَّة، بل اقتصر علىٰ المُستويات النِّهائية من التَّعليم المدرسي.
وفي الأخير، وبعدما أنهت هذه الأطروحة مسارَها؛ فإنَّه لا يسعُنا إلَّا أن نعترِف أنَّنا بِمُجرَّد أن نَتَطلَّع إلىٰ تغيير طريقةِ تجديدِنا لمناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة، فإنّنا نعترف منذ البداية بضرورة تجاوُز الطَّريقة الحاليَّة وجعلها أكثر استجابةً للإكراهات والتَّحدِّيات، وما قد يدفعنا لهذا الاعتراف هو محدوديَّة أو قصور الطُّرق السَّائدة عن مُواجهة الإكراهات القائمة وكَسْب الرِّهانات التَّربويَّة المستقبليَّة.
ولقد كان السَّعيُ نحوَ إحداث ذلك التَّغيير ضالَّتنا في هذه الأطروحة، فقمنا أوَّلًا بتحديد الإكراه الأكثر خطورة علىٰ مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة، ثُمَّ قُمنا برصدِ التَّحدِّيات الحقيقيَّة التي يطرحُها علىٰ مناهج المادَّةِ في الواقعِ المُعاصِر، ولم يعتمِد الباحِثُ في رصد تلكُم التَّحدِّيات علىٰ قراءاتٍ خارجيَّة حول الموضوع، بل اختارَ أن يُحدِّدَها مِن خلالِ اقتحام واقعها بالبحث المتفحِّصِ والنَّاقِد وذلك من خلال الدِّراسةِ التَّطبيقيَّة لمناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة، دون أن يُغفِل في أيِّ لحظةٍ فرضيَّته التي مفادها: أنَّ الإكراه الحقيقيَّ الذي تتولَّد عنه مُجمل تلك التَّحدِّيات المُعاصِرة هو الإكراهُ الأيديولوجيّ.
وبِناءً علىٰ ذلك؛ يكون الباحِثُ قد اختارَ في أطروحته هذه قراءة المُتوَقَّع في ضوء الواقع، والمُستقبل في ضوء الحاضِر، إذ هُما مُتَّصِلان غير منفصلين، فكان مِن نتائج الأطروحة ما يلي:
ـ يسمح التَّداخُل الكبير بيْن السِّياسة التَّعليميَّة والمُساعدات المادِّية والقروض الدَّوليَّة بتسَلُّل التَّوجُّهَّات الأيديولوجيَّة إلىٰ مراكزِ صناعةِ القرار التَّربويِّ، حيث تتمكَّن بفعل ذلك مِن ممارسة ضغوطها “النَّاعِمة” لإحداث التَّغييرات القسريَّة علىٰ مناهج التَّعليم بما فيها مناهج مادَّة التَّربيَّة الإسلامية.
ـ أصبح الواقع الأيديولوجيّ العربيُّ واقِعًا اغترابيًّا بفعل عوامل متعدِّدة، كما أصبح مسرحًا لأيديولوجيَّاتٍ مختلفةٍ لا تزال تفتك صراعاتها بمُختلف مجالات حياته بما فيها المجال التَّربويِّ.
ـ دلَّت مؤشِّرات دراسة واقع مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة علىٰ إخفاقها (بشكلٍ كُلِّيٍّ في بعض الحالات وبشكلٍ جُزئيٍّ في بعض الحالات الأخرىٰ) في مواجهةِ الصِّراع الأيديولوجيِّ.
ـ بناءً علىٰ هذه النَّتيجة الآنفة الذِّكر؛ فإنَّ مؤشِّرات المُتوقَّع دالةٌ بأنَّها مِن باب أولىٰ عاجِزةٌ عن ولوج مُستقبلها بنفَسٍ قوِيٍّ قادرٍ علىٰ المُدافعة.
ـ لقد تعرَّضت مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة لهجوم أيديولوجيٍّ لا يزال مُستمِرًّا وسيظلُّ، وعانت تلك المناهج من آثار هذا الهجوم والصِّراع معه، وحاول مُناصروها أن يُدافِعوا عنها، ولكن ظلَّ واقعُها في تراجُعٍ وظلَّ تاريخُها المُعاصِر تاريخ انهيارٍ يصِفُه البعضُ بالكارثيِّ.
ـ في الوقتِ الذي استمرَّت فيه مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة في صراعها مع «الأيديولوجيات» سواء الضَّاغطة أو المُشاكسة كان العالمُ يواصِلُ مسيرة التَّقدُّم التَّربويِّ بشكلٍ سريعٍ ومُروِّعٍ أحيانًا، وبدل أن تتموقعَ المادَّة داخل ذلك التَّقدُّم وتُسهِمَ فيما يجبُ عليها أن تُسهِم فيه؛ ضخَّمت المادَّة مِن الصِّراع الأيديولوجيِّ بل وأذكت نيرانه أحيانًا بسبب خطابها.
ـ إنَّ مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة التي ظلَّت تحتفِظُ في الواقع العربيِّ بمكانَتها رُغم كُلِّ الأراجيف ومُحاولات المسخ والنَّسخ، سوف تُواجِهُ مُتوَقَّعًا لا يحتفي بها كما يحتفي بها الواقع، وما حالة التَّراخي الناتجة عن التصوُّرات التي يحملًها المُتعلِّمون عن محتوىٰ المادَّة، والتي بدأت تستفحِل شيئًا فشيئًا إلَّا مؤشِّرًا من مؤشِّرات الأزمة التي ستدخُلها المادَّة في المُستقبل.
ـ لا زالت مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة في العالم العربي تبحث عن النَّموذج القادرِ علىٰ تقديم الحلولٍ، وهي تعلمُ في الوقتِ نفسه أنَّها تحْمِل في ذاتِها عواملِ التَّعافي، إلَّا أنَّها لم تُدرك بعد طريقها الصَّحيح نحو ترجمة تلك العوامل إلىٰ رؤًىٰ قابلة للتطبيق والأجرأة والسَّيرِ بخطىٰ واثقةٍ نحوَ المُستقبل.
ـ إنَّ المناهج التَّعليميَّة في سياقها التَّطوُّريِّ عبارةٌ عن صيرورةٍ وليست نهايات، فهي قابلة للتَّحديث عبر مرور الزمن، ولا مجال للجمود علىٰ صيغةٍ واحِدة، ولذلك؛ فإن كانت الأطروحة قد أفرزت أربعة تحدِّياتٍ مُعاصرة لرفع مناهج مادَّة التَّربية الإسلاميَّة فإنَّ هذا العمل سيظلُّ بحاجةٍ إلىٰ المُراجعة والفحص مع مرور الزَّمن ومع ما يستجدُّ مِن مُستجدات.
كانت هذه أهمَّ النَّتائج التي رأىٰ الباحثُ أنَّها تكتسي أهمِّيَّةً كُبرىٰ بيْن باقي النَّتائج الأخرىٰ، أمَّا فيما يخصُّ التَّوصيَّات، فلابُدَّ مِن كلمةٍ قبل الشُّروعِ في ذكرها، وذلك مِن باب الاعتراف بقيمةِ ما جاءه به الفصل الثَّالث: فإنَّ ما ورد فيه مِن رؤىٰ اتَّخذت طابع المحدِّدات المنهجيَّة والتَّوجُّهات المُستقبليَّة يُمكن أن يُعتبرَ في حدِّ ذاته زُبدةَ التَّوصيات التي قد نذكرها الآن، ولكنَّنا سنكتفي هُنا ببعض التَّوصيات المنهجيَّة العامَّة التي من شأنها أن تبلوِرَ معالِمَ الاستفادة من تجربة الباحث في إنجازه لهذه الأطروحة، ولهذا فإنَّ الباحِثَ يوصي بالآتي:
ـ العمل علىٰ تكوين العقل التَّربويِّ العربيِّ الإسلامي الذي يُعمِل الاستبصار البَعديِّ لتظلَّ جهودنا في تطوير المناهج التَّعليميَّة لمادَّة التَّربية الإسلاميَّة جهودًا استباقيَّة مُتفاعِلةً ومؤثِّرةً لا مُنفعِلَةً ومتأثِّرةً.
ـ ضرورة العمل علىٰ إنتاج المعرفة التَّربويَّة الأصيلة والمُعاصرة لنستطيع اقتراح حلولنا المُناسبة لنا، ونستطيع تمحيص الحلول الوافدِة المُقترَحة علينا.
ـ تجديد وضخ النَّفسِ الأكاديميِّ المُؤسَّس في أبحاثنا ودراساتنا المنتميَّة إلىٰ حقل التَّربية والدِّراسات الإسلاميَّة.
ـ استئناف القول في طبيعة رفع التَّحدِّيات التي حدَّدتها الأطروحة وذلك باختبار ما جاء بصددِها مِن مُحدِّداتٍ منهجيَّة وتوجُّهاتٍ مُستقبليَّةٍ.
مُلحق: الخُطاطات المنهجيَّة:


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بالإضافة إلىٰ ذلك هُناك أسبابنا الذَّاتية المُتمثِّلة أوَّلًا في أنَّ هذه الأطروحة تُنجَزُ في نفس البَلد، كما أنَّ المُشرِف عليها كان له إسهام وازِنٌ في تطوير منهاج هذه المادَّة بالمملكة المغربيَّة ثانِيًّا، ثُمَّ إنَّ مُنجِزها مُدرِّسٌ لمادَّة التَّربية الإسلاميَّة بمدارسها العموميَّة ثالِثًا.
[2]كان هذا المنهاج مُنفَّذًا في المملكة المغربية أثناء تسجيل هذه الأطروحة سنة 2015م، ثُمَّ تمَّ تغييره بعد ذلك سنة 2016م في سياقٍ سنُعرِّجُ عليه بالتَّفصيل في الفصل الثَّاني إن شاء الله تعالىٰ.